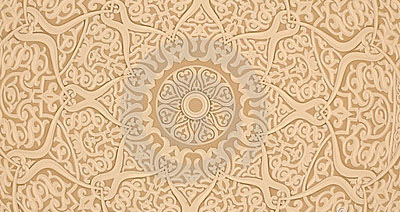ذلك السفر الطويل, وانقلاب الليل إلى نهار, وعبور المحيط من قارة إلى أخرى, كلها أمور تجعل المرء مهيأ للدخول في خضم هذا المجتمع الذي يبدو أليفا وغريبا في الوقت ذاته, وأعني به المجتمع الأمريكي الذي قضيت بين ربوعه زهاء الشهر الكامل واكتشفت خلال هذه الفترة أنه بقدر ما نعرف عن هذا المجتمع بقدر ما توضح المعاينة عن قرب أن من رأى ليس كمن سمع.
فعلى مدى هذا الشهر الذي قضيته في الولايات المتحدة الأمريكية متجولا ومراقبا سير الحياة من حولي, أتابع وسائل إعلامه, تكونت لدي قناعة شخصية أن هذا المجتمع يسير إلى نوع من المتغيرات التي سوف تبدل من صورته إلى درجة كبيرة, ويمكن القول إن صورة أمريكا كتجسيد حي قائم على الفلسفة المادية العقلانية في سبيله إلى التحول, فخلال العقد الماضي ومع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي اعتقد هذا المجتمع بصورة أو بأخرى أنه مركز الكون, لأنه يحتوي على عناصر من القوة والمعرفة تعطيه القدرة على التحكم في عالمنا المعاصر, كما أن الثورات المتعاقبة, وأعني بها ثورة الحريات المدنية وثورة المعلومات وثورة الهندسة الوراثية, أعطت هذا المجتمع قوة إضافية كي يضع نسقا أخلاقيا وفلسفيا مغايرا للأنساق التقليدية التي نعرفها, هذه القناعات التي سادت العقد الماضي في سبيلها إلى التغير الآن, ويناقش المعلقون الأمريكيون في أكثر من مستوى مغزى هذه الاختلافات بين عقد مضى كان طابعه الثقة والثبات, وذلك العقد(الحالي) ذي المزاج الجماعي المتوتر, من المفارقة والقيم المتغيرة, الذي تعيشه أمريكا الآن, وهو الأمر الذي يهددها بفقد دورها المركزي.
هذه الحالة هي وليدة العديد من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية, ولكنني أعتقد أن الذي دفع هؤلاء المحللين إلى تلك النظرة المتشائمة ليس إحساسهم بقرب فقدان المركزية الأمريكية, بقدر إحساسهم بفقدان مركزية الرجل الأبيض, أو “الواسب “wasp الذي كان يعد حتى وقت قريب التجسيد المباشر للحلم الأمريكي, و”الواسب” هو اختصار حروف الرجل الأبيض المنحدر من عروق أنجلو ـ ساكسونية والذي يدين بالمذهب البروتستانتي, فقد ضاع هذا اللون المتميز وسط خضم الألوان التي يموج بها المجتمع الأمريكي الآن, فعندما قامت الحرب الأهلية الأمريكية العام 1861م لم يكن هناك إلا تصنيفان للون هما: الأبيض والأسود, أما الآن فإن تصنفيات اللون تصل إلى عشرات الأنواع, وقد لمست هذا الزحام اللوني في كل مكان ذهبت إليه تقريبا, وكنت أتساءل دوما: هل توجد “ميكانيزمات” دائمة لاستيعاب وصهر كل هذه الألوان بكل ما تمثله من ثقافات مختلفة ومتنافرة أحيانا, وهل يمكن التوفيق تحت مظلة المجتمع الأمريكي بين الأبيض الأوربي, والخلاسي اللاتيني والأسود الأفريقي والمسلم العربي والأشهب الآسيوي? هل هناك وسائط قادرة على استيعاب كل هذه الثقافات والأجناس النازحة وإعادة تشكيلها ثم إعادة إطلاقها محليا وعالميا?
ترويض الجيل الثاني
ربما لا ينصب اهتمام المجتمع الأمريكي الآن على الجيل الأول من الهجرات المتعاقبة, فهؤلاء لا توجد أمامهم فرص كبيرة للنمو أو الحركة, وهم يقضون معظم حياتهم في هذا الوطن الجديد غرباء ثقافيا, وفقراء ماديا, عاجزين عن الاندماج في هذا المجتمع الجديد فضلا عن الانصهار فيه, لذا تبقى هذه المجموعة في قاع المجتمع, تزاول أعمالا غير مؤثرة كالمهن اليدوية التي لا تحتاج إلى مهارات عالية, أما الشريحة العليا من هذه الفئة والتي تحتوي على حملة المؤهلات العلمية (أطباء, مهندسين وخاصة هندسة الكمبيوتر), فهذه الفئة تجد لها مكاناً وسط جموع الطبقة الوسطى, وتبقى رغم ذلك محملة بتراثها الثقافي وسلوكها الاجتماعي والديني بصورة يصعب التخلص منها.
ولكن التركيز الأساسي ينصب على الجيل الثاني المتوالد من هؤلاء المهاجرين, هؤلاء الأبناء الذين يولدون في أحضان الثقافة الأمريكية ويتشربون قيمها من خلال مناهج التعليم والاحتكاك بالواقع اليومي بهذا المجتمع, وهكذا تبدأ تلك الهجرات المتلاحقة الانسلاخ التدريجي من ثقافاتها القديمة والتقليدية لتتبنى السلوك والقيم الأمريكية, ولم تكن هذه العملية سهلة أو سريعة, ولكنها أخذت مداها طوال الأعوام السابقة, ويجب أن نذكر أن الفضل في إنجاح هذه السياسة يعود إلى العملية التعليمية الأمريكية التي وضعت على أسس تتجاوز الاختلافات العرقية وتحث على التفاعل بين الألوان المختلفة ولا تميز بينها, وإلى الدور النشط والفعال للإعلام الأمريكي بكل أنواعه, فقد عد جلوس الأبيض بجانب الزنجي في الستينيات من القرن الماضي ثورة صادمة للعديد من القوى المحافظة, وعندما وقف “مارتن لوثر كنج” يهتف أمام البيت الأبيض: “لدي حلم”, لم يكن يتصور أن تصل الأمور إلى هذا المدى وأن تساهم العولمة بهذه السرعة في تحقيق حلمه الذي عمل من أجله طويلا, فقد كان يدرك وقتها أنه لا توجد حلول سهلة لعدم الثقة التي أوجدها صراع الحقوق المدنية بين البيض والسود, ولكن رياح العولمة الجديدة أوجدت العديد من المؤسسات غير الحكومية والتي تعبر العرق وتتجاوز الحواجز العنصرية وتساهم في زيادة التعاون بين أركان المجتمع رغم ألوانه المختلفة.
لمسة الديمقراطية
إنها الديمقراطية ولمستها السحرية, وهي تتجلى في هذا المجتمع عندما تعطي أقصى الضمانات للحريات المدنية, وإذا كنا نتحدث في العالم الثالث عن حاجتنا إلى الشفافية في تعاملنا مع الأمور العامة فإن الحقيقة هنا عارية إلى درجة تثير الذهول. وإذا كنا نحلم بالنقد الواضح والصريح لكل عيوبنا فإن الأمور كلها هنا موضوعة تحت المجهر, والأخطاء التي نراها عندنا عادية جدا ونعدها جزءا من تجاوزات أي نظام, تعد هناك أخطاء فادحة لا يمكن السكوت عنها. ولا أعني هنا أن المجتمع الأمريكي مجتمع مثالي, فاليوتوبيا لم توجد بعد, ولكنه بالتأكيد قد استفاد من تجارب الآخرين, بل واستفاد من تجربته الشخصية حين أدرك أن سنوات الفصل العنصري الطويلة ساهمت في رفع درجة العداء الاجتماعي وتسببت في خنق روح التغيير والابتكار التي قام عليها المجتمع الأمريكي, وجعلت الرئيس الراحل كيندي يقول قبل أن يُغتال: “إنني أحكم أمة منقسمة” وربما كان قد دفع حياته ثمنا لهذا الانقسام, فالممارسة الحقة للديمقراطية لا تضمن الحريات المدنية فقط ولكنها تحض على قيم العدالة والتوازن بين أطراف المجتمع.
وقد ساهم في إذكاء هذا الأمر تلك الدرجة من “قبول الآخر” التي يتميز بها المجتمع الأمريكي, وهي مسألةتعود في جذورها إلى الفكر الليبرالي الأوربي, إنها محاولة لفهم الآخر كنسق متكامل يتضمن قبول لغته وعاداته وتقاليده ومعتقداته الدينية ومحاولة فهمه في هذا الإطار. وقد ساعدت هذه النظرة أوربا إلى حد كبير على دراسة الحضارات المغايرة لها وفهمها بل والتغلب عليها أيضا. لقد اكتسبت الحضارة الغربية قوتها من قدرتها على الفهم والاستيعاب, والمجتمع الأمريكي هو الوريث الشرعي لتلك القيم الغربية, لذا فقد استطاع هذا المجتمع باتباع سياسة قبول الآخر أن يستقطب أفضل الأدمغة في كل مجالات التطور البشري, فقد أدرك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة أسطورة الجنس الآري أن العبقرية ليست وقفاً على عرق معين, ووصل من خلال الخبرة الحضارية إلى أن هناك عاملا مشتركا أعظم بين الأنشطة العقلية يتخطى النوع والجنس إلى الجذر الواحد لـ”الجينوم” وهي الحقيقة التي كشفت عنها حقائق الثورة الوراثية فيما بعد.
إن أمريكا, على حد تعبير مجلة “النيوزويك” في أحد أعدادها الأخيرة, تشهد أكبر عملية انصهار عرفتها في تاريخها, وقد لمست هذا الأمر بنفسي في كل مكان ذهبت إليه, وقد تراجعت قليلا نسبة الزواج بين الأبيض والزنجي, أو أنها أصبحت مسألة عادية لا تلفت الأنظار لترتفع نسبة الزواج بين الأبيض وذوي الجذور الآسيوية أو اللاتينية, بل إن ولاية مثل كاليفورنيا وهي من أكثر الولايات تقدما وثراء تتحول ليصبح الأبيض فيها هو الأقلية بينما تسود فيها الأقليات العرقية الأخرى, والشيء نفسه قد حدث في وادي السليكون في مقاطعة سانتا كلارا, وهو الوادي الذي يحتوي على أهم الشركات المتطورة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات, فقد توافد إلى هذا الوادي عشرات الآلاف من الهنود والصينيين الخبراء في هذا المجال, والذين كان السوق الأمريكي متعطشا إليهم بشدة, ولم تكن الجامعات الأمريكية قادرة على تخريج الأعداد الكافية منهم. وقد ساهم هؤلاء لا في تغيير التركيبة السكانية في الوادي فحسب ولكن في تغيير مستواه الاقتصادي أيضا, فعلى مدى تطور هذه الصناعة انفصل العديد من هؤلاء الخبراء عن الشركة الأم وكونوا شركاتهم الصغيرة التي سرعان ما نمت واستقدمت المزيد من العمال. وقد نشرت مجلة (فورتشن) الأمريكية التي تهتم بعالم الأعمال أخيرا قائمة بأسماء 700 من أكثر الأمريكيين ثراء, وأظهرت القائمة أن حوالي 70% من هؤلاء الأثرياء يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والأهم أنهم كانوا ينحدرون من أصول آسيوية.
رياح العولمة
إنها رياح العولمة تهب من وادي السليكون ومن بقية أرجاء أمريكا لتهز بدواماتها المتلاحقة العالم كله, فالشعوب التي مازلنا نطلق عليها العالم الثالث ـ رغم أن العالم الثاني بأسره قد انهار ـ قد أصبحت أسيرة للتأثيرات الثقافية الأمريكية المحمولة على أجنحة الأقمار الصناعية ووسائطها المختلفة كالسينما والإنترنت والكتب والموسيقى والأزياء بل واللغة أيضا, فالإنجليزية قد اكتسبت عالميتها من خلال المفردات واللهجة الأمريكية, حتى أن الإنجليز أنفسهم اضطروا لتطويع لكنتهم العريقة لمقتضيات هذه اللغة الجديدة عندما يتحدثون إلى الغرباء, وهكذا نجد أنفسنا أمام حالة نادرة في التاريخ البشري تطبق فيها الأساليب والقواعد المحلية لمجتمع ما على بقية أرجاء المعمورة.
ولعل صناعة الكمبيوتر ـ كما ذكرنا من قبل ـ هي التي ساعدت في الإسراع بنقل كل تأثيرات العولمة, فهيمنة أمريكا على هذه الصناعة (وأعني بهذه الهيمنة صناعة البرمجيات softwear ) بينما تحبذ أمريكا أن تتم صناعة الأجهزة hardware خارجها للاستفادة من رخص العمالة والمواد الخام) تؤهلها بلا جدال للتحكم في مسيرة العقل البشري المعاصر, ولعل آخر الصيحات القادمة في هذا المجال هو جهاز الكمبيوتر الذي يعمل على الإنترنت ويقوم هؤلاء الذين لا يمكنهم استعمال لوحة المفاتيح باستخدامه, وسوف يستجيب هذا الجهاز لصاحبه من خلال التوجيه الصوتي, ويعمل بالأمر المباشر دون حاجة لمعرفة القراءة والكتابة, أي أن رياح العولمة لن تترك حتى هذه الشريحة الهامشية دون أن تمسها وتغير مسارها.
ولا يتوقف الأمر على التأثير الثقافي المباشر بكل تفاعلاته ولكنه أيضا يمتد لعصب الحياة المعاصرة وهو الاقتصاد, فقد تحولت بورصة نيويورك أو سوق الأوراق المالية بها لتصبح سوقا لكل العالم, فبواسطة الإنترنت يمكن لأي فرد في أي مكان في العالم ولو كان في أعماق الغابات أن يدخل إلى هذا السوق وأن يحول إليه أمواله وأن يبيع ويشتري كأنه حاضر وسط صخب البورصة في شارع (وول ستريت). هذا السلاح الذي تملكه أمريكا يؤهلها لأن تتحكم في كل رءوس الأموال في العالم, ويجعلها شريكا مهما في كل التداولات المالية المحلية التي تخص أدق المشاريع في العالم.
حتى الرئاسة.. تتغير
وقد شهدت الحياة السياسية أخيرا تطورا كبيرا تتجاوز فيه نموذج “الواسب” الذي كان ومازال يتحكم في الحياة السياسية الأمريكية وذلك عندما تم اختيار أمريكي يهودي للترشيح لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة للانتخابات القادمة. ومن الصحيح أن الدستور الأمريكي لا يعطي صفة دينية للنظام أو الدولة ولكن شخصية “الواسب” بديانته المسيحية البروتستانتية كانت هي دائما المسيطرة, ربما شذ كنيدي عن تلك القاعدة قليلا لأنه كان يعتنق الكاثوليكية, ولم يتح لأي أقلية دينية أو عرقية الوصول من قبل إلى سدة الرئاسة أو نيابتها. إن هذه النقلة ـ إن تمت ـ سوف تشكل مرحلة جديدة في تاريخ أمريكا السياسي, وبغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء هذا التحول فإننا أمام تغير خطير في النظرة الأمريكية لمنصب الرئاسة وهو الذي يعطي لشاغله صلاحيات واسعة تجعله أقوى رجل في العالم. فالوفاة المفاجئة للرئيس أو الترشيح لمنصب الرئاسة في انتخابات قادمة ـ كما حدث لكثير من نواب الرئيس ـ أمور كفيلة بدفع هذا النائب الذي ينتمي إلى الأقلية الدينية اليهودية إلى قمة السلطة, ويفتح الباب بالتالي أمام أقليات عرقية ودينية أخرى حتى تنشط وتخطط للوصول إلى هذا الموقع, ولعل هذا ـ وهو أمر لم يعد مستبعدا ـ يعطي فرصة للأقلية الإسلامية لأن ترسم الخطط من أجل ترسيخ مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى يأتي اليوم الذي تستطيع أن تفرض فيه مرشحها على الأحزاب المتنافسة على الرئاسة.
إن فرص الأقليات المتحدرة من أجناس وأعراق غير أوربية الأصل كالزنجية والآسيوية, والمنتمية إلى ديانات أخرى كالبوذية والإسلام تصبح أكثر توافرا في المستقبل إذا ما استطاعت هذه الأقليات أن تنظم قواها وان تتغلغل في النسيج المالي والسياسي والحزبي للنظام الأمريكي.
ولكن حديثي عن الشق الإيجابي في اختيار نائب للرئيس من الديانة اليهودية لا ينفي وعيي بالشق السلبي من هذا الأمر, خاصة بما عرف عن التزام هذا النائب الشديد بالتعاليم اليهودية, وكذا مواقفه الدائمة في دعم إسرائيل ومصالحها أثناء عضويته في الكونجرس الأمريكي, ومن البديهي أن مثل هذا النائب سوف تتأثر مواقفه, ويمتد هذا التأثير إلى رئيسه وحزبه للانحياز إلى الجانب الإسرائيلي, وإذا لم نعمل حسابا لهذا الأمر فإننا نخدع أنفسنا بأحلامنا أو بجهلنا للسياسة ودور القيادة في تشكيل المواقف والقرارات.
إن الظاهرة الأمريكية تعطينا الكثير من الدلالات, أهمها أن العرق خرافة, وأنه لا يوجد أي دليل علمي أو عملي على تفوق عرق على آخر بفضل عوامل الوراثة, وقد اكتشفت أمريكا ذلك في وقت مبكر, واكتشفته السلطة التي كانت تحكم جنوب إفريقيا أخيرا وسوف تكتشفه إسرائيل في المستقبل القريب. وثاني هذه الدلالات أن كل الصراعات العرقية والدينية تعود في جذورها إلى أسباب اقتصادية وسياسية, فافتقاد العدالة في توزيع الثروات وقمع فئة من أجل مصلحة فئة أخرى هو أكبر مولد لتلك الفتن. وثالث هذه الدلالات أن الأمم تقوى بمقدار درجة انفتاحها على ما فيها من تعددات عرقية وإثنية وإيمانها بالوحدة من خلال التنوع.
ولا تنتهي الملاحظات حول الظاهرة الأمريكية وإن كنت قد اكتفيت بجانب واحد من جوانبها, فذلك المجتمع المتعدد الأوجه في حاجة إلى مزيد من الفهم لأن الظاهرة الأمريكية هي جزء رئيسي ومهم من ظاهرة العولمة التي نعيش اليوم وسط رياحها الهوجاء.
 د. سليمان إبراهيم العسكري
د. سليمان إبراهيم العسكري