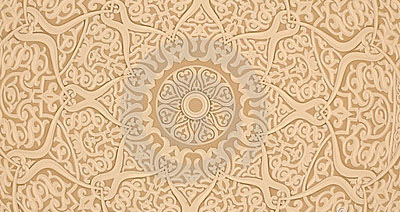في “حديثنا الشهري” بعدد مايو الماضي من هذا العام والذي كان يحمل عنوان “سلام الهيمنة الإسرائيلية، إلى أين المصير؟” بدأناه متسائلين: “هل هي التسوية النهائية، حقا، تلك التي توشك حلقاتها أن تكتمل، مع ما يقال عن اقتراب المسار التفاوضي السوري – الإسرائيلي من إطار عام لاتفاق ما، ومع تواصل تلك المباحثات الفلسطينية – الإسرائيلية التي استطالت دون أن ندري إن كانت تصنع التمهيدات لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة أم لا؟”.. وكان جوابنا – بعد استقراء كل ما أسفرت عنه الوقائع والنوايا هو النفي.
ثم جاءت أحداث انتفاضة الأقصى، المشتعلة منذ ثلاثة شهور حتى الآن واحتدام المواجهة بين حجارة الانتفاض الفلسطيني ونيران القمع الإسرائيلي القاتلة، وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى تحت وابل الرصاص الحي لجيش مدجج حتى قمة رأسه بالسلاح، لتؤكد وتحتم الإجابة بهذا النفي.
وقد ذكرنا أن “تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي يؤكد بوضوح أن الحركة الصهيونية في فلسطين، وعلى امتداد العالم لم تنظر أبدا إلى المشروع الاستيطاني في فلسطين إلا من منظور واحد هو القمع الدائم للجيران العرب، وربطهم، بقوة هذا القهر والإرغام، بعجلة المشروع الصهيوني الذي سيعتمد في بقائه واستمراره – بعد تجليه في شكل دولة هي الأكثر تفوقاً، عسكرياً واقتصاديا في المنطقة – على التفوق الدائم لجانب واحد، وهذا التفوق لابد أن يقابله، بالضرورة، ضعف عربي وتبعية دائمة لإسرائيل المتفوقة والمهيمنة”.
استئصال الآخر
وقد أثبت هذا القمع الصهيوني الوحشي ضد رماة الحجارة الفلسطينيين – الذين فقدوا صبرهم وطال انتظارهم للاستقلال والدولة المختزلة حتى أصبحوا الشعب الوحيد في العالم كله الذي لايزال يخضع لاحتلال عسكري مباشر – أن التعايش بين اليهود والعرب والمسلمين في نظر الحركة الصهيونية الاستيطانية أمر يتناقض مع ثقافة الفكر اليهودي الراسخة عن “شعب الله المختار” الذي ميزه الله عن العالم، وسخر بقية الخلق قاطبة لخدمته وخضوعهم لقيادته ولمصالحه الدنيوية!
فإسرائيل قد اكتسبت مبررات وجودها في فلسطين وفق ثقافة قديمة ضاربة في أعماق التاريخ، لأن مبرر هذا الوجود هو تحقيق إقامة الدولة “اليهودية” النقية التي لا يشاركهم فيها أحد من غير اليهود، وما مبرر وجود الآخرين معهم أو حولهم إلا لدعم هذا الحلم اليهودي الديني، لذا نراهم لا يستنكرون شيئاً مما ينزلونه بغيرهم من ظلم وإرهاب وقتل يصل إلى حد استخدام أساليب الإفناء لوجود الآخر.. كالقتل المتعمد للأطفال، وهدم المنازل، وإزالة الوجود المادي للسكان الأصليين وتزوير تاريخهم وانتمائهم للأرض التي “يزعمون أنها اختيرت من قبل الرب لتكون أرض الميعاد”!
إن السيطرة التراثية للفكر اليهودي، والاستناد إلى ثقافة الشتات والإحساس الدائم بالاضطهاد وعدم الوثوق بأي شيء في هذا العالم سوى تعاليمهم التوراتية، هي التي تحكم اليوم الدولة اليهودية في فلسطين، وكل ما يقال عن العلمانية واليسارية وقوى السلام في المجتمع الإسرائيلي نراها قد انهارت في أيام قلائل أمام الرعب من حجارة الفلسطينيين، وتخلي الجميع عن علمانيتهم ويساريتهم والتحموا مع حملة الفكر التوراتي القديم ضد شعب أعزل مقهور مسلوب الأرض والدار ومعزول حتى من الدعم والمساندة من العالم الخارجي.
إن الطائرات والدبابات والصواريخ الإسرائيلية وهي تدك منازل المدن والقرى الفلسطينية على رءوس ساكنيها، تكشف عن ثقافة المسلك الصهيوني الحاكم لمجريات السياسة في إسرائيل، التي ترى العرب قوما لا يفيد معهم سوى القوة، وكلما استخدمت مزيداً من القوة ضدهم وتم تصعيدها تراجعوا أمامك أكثر!
سلام مختلف.. سلام مستحيل
لقد أسقطت حجارة الأطفال الفلسطينيين القناع عن الوجه الحقيقي للعنصرية المتأصلة في التعامل الإسرائيلي مع “الجيران” الفلسطينيين والعرب، وبات واضحاً وأكيدا، مع تواصل انتفاضة الأقصى وتحديها للاستعمار الإسرائيلي بكل آلته العسكرية القمعية، أن إسرائيل تتحدث طوال حلقات تفاوضها مع العرب منذ “مؤتمر مدريد” عن سلام مختلف عن السلام الذي يتحدث عنه العرب – مع كل تواضعه – وأنها تبحث على مستوى “الكلام” عن تسوية “عبر مسارات التفاوض” مع العرب بينما تسعى على مستوى “الفعل” إلى فرض واقع نابع من ثقافة الهيمنة والاستعلاء اليهودي على “الجيران”، أو إلى إملاء “سلام” التفوق الصهيوني والضعف العربي.
ويمكننا أن نعيد قراءة مشروع “الشرق أوسطية” الذي بشر به شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ضمن هذا الفكر اليهودي التوراتي.
إن واقع التركيبة الحالية لمنظومة الحكم في إسرائيل، وكما أشرنا في مقالنا سالف الذكر، يتسم “بالتفوق الواضح للجناح اليميني التوراتي المتطرف، وهو الجناح الذي يعتمد في فكره وإيمانه على أن الوجود الصهيوني قائم على إلغاء الطرف الآخر، وهو هنا الفلسطيني العربي المسلم، وهؤلاء المتدينون المتخلفون والمتعصبون هم الذين يرجحون الآن – ولفترة طويلة قادمة – ميزان قوى الرأي في السلطة الإسرائيلية”.
وقد تجسد إخفاق هذا الفكر في قبول التعايش مع الآخر “الفلسطيني” والمشاركة المتكافئة في بناء المستقبل، حتى ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني الذي رضي منذ أكثر من خمسين عاما أن يصبح جزءا من دولتهم، رفضوه بسرعة فائقة وأضافوه – رغم أنه يحمل الهوية الإسرائيلية – إلى قائمة العدو الفلسطيني الذي يجب أن يفنى!
هذه الثقافة اليهودية المتسلطة والمدعمة بقوة التطور التكنولوجي والعسكري الغربي تنظر للسلام في المنطقة ومستقبل وجوده من زاوية مناقضة تماما للنظرة العربية للسلام والتصالح.
فأي دولة ديمقراطية علمانية هذه التي تؤمن وتعمل على إلغاء أكبر أثر ديني في التاريخ لشعوب المنطقة بأسرها وللشعوب الإسلامية كلها، وأقصد به المسجد الأقصى، ولا تضع اعتباراً لآي من القيم الثقافية والتراث الديني لتلك الشعوب من أجل وهم السعي لإثبات أن تحت هذا الأثر موقعا أو دليلا على وجود معبد يهودي (الهيكل) تهدم منذ آلاف من السنين؟
فكيف لنا أن نعتمد ونمضي على طريق الثقة والتصديق مع فكر وثقافة تلك هي منطلقاتها في القرن الواحد والعشرين.
إن تصادم الثقافات بين العرب والإسرائيليين يضع صيغة السلام “المدريدي” في قائمة الوفيات، ويؤكد الحاجة الملحة إلى طرح صيغة بديلة فاعلة يقودها الفلسطينيون ويدعمهم العرب والقوى العالمية ذات المصلحة الحقيقية في إقامة سلام واستقرار في منطقتنا العربية.
هذه الصيغة لابد أن تنطلق من يقين كامل بأن الصراع لن ينتهي بسهولة ويسر، أو بقوة سحرية، ولابد من خلق أشكال جديدة لآلية هذا الصراع تنطلق من مبدأ أن السلام يقوم ويسود في حالة واحدة هي خلق ” توازن قوى” بين الطرفين المتصارعين يتقوى فيه الطرف الأضعف تدريجيا على حساب تراجع قوة الطرف الأقوى تدريجيا أيضا.
طريق للخلاص
إن دماء الشهداء التي تسيل كل يوم يجب أن تتحول إلى فعل، كما أن مشاعر الغضب العميقة التي تعم الشارع العربي يجب أن تتحول إلى طاقة دافعة. ولن تجدي صيحات الحرب المتوالية والدعاوى الصارخة من أجل فتح الحدود. فالحرب النظامية لم تعد تدور على الأرض. وحرب كوسوفا هي خير دليل على ذلك. ولا أعتقد أن الجيوش العربية قادرة على اختراق السهول والوديان فضلا عن اختراق الحدود العربية المصمتة. ولكن الكفيل بإعادة الحرب إلى الأرض هم أبناء الشعب الفلسطيني نفسه، فهم وحدهم القادرون على الضغط من أجل تحرير المدن الفلسطينية وهم أيضا القادرون على انتزاع اعتراف العالم بحقهم العادل في النضال ضد المحتل.
ولكن هذا الأمر يجب ألا يتوقف عند إلقاء الأمر على عاتق الآخرين، فهؤلاء الناس المحاصرون في حاجة إلى من يدعمهم ماديا ومعنويا حتى يمكنهم مقاومة ذلك العنت الإسرائيلي. ويجب أن تكون لهم قنواتهم المالية الخاصة بعيدا عن المؤسسات الإسرائيلية، كما أن الحجارة لم تعد سلاحاً كافياً أمام كل هذا القمع والعنف المبالغ فيه. وكان لابد من إيجاد وسائل أخرى ليستطيعوا الذود عن أنفسهم وعن وجودهم. وسواء أمسك الفلسطيني بالحجارة أو بالسلاح فلن تفعل إسرائيل أكثر مما فعلت، فقد استغلت أقصى ما في ترسانتها من أسلحة سواء كانت دبابات أو طائرات أو صواريخ.
إن تجربة “حزب الله” اللبناني أثبتت شيئين أساسيين أولهما: أن إسرائيل قابلة للهزيمة إذا وجدت من يرد عليها، وثانيهما: أن العالم لا يفهم ولا يحترم إلا من يملك القوة والإقناع. كما أن الصراع مع الدولة العبرية في إسرائيل ممتد الحلقات، متعدد الأطوار، متسع الميادين، يمتد من الحجارة والضغط العصبي والنفسي على المجتمع الإسرائيلي، إلى ميادين الإعلام الذي يجب أن ندخله متسلحين بأدوات الثقافة والاقتصاد والعلم لا بالصراخ والخطابة. إن من المهم أن نمتلك القدرة على معرفة الآخر وكيفية الوصول إليه والتفاهم معه، وخلق الروابط الاقتصادية والمعرفية معه، وفهم علم المصالح المتبادلة بين الأمم والدول في هذا العالم المتسارع الخطى والتحولات.
إن ساحات معركة الإعلام والتواصل مع العالم الخارجي أصبحت من الأسلحة الأكثر تأثيرا وفتكاً في الصراع العالمي، فثورة الاتصال والمعلومات وضعت العالم أمام الحقائق مباشرة، ومهما حاولت قوى متحكمة في التأثير على حقائق الصورة ومحاولة تشويهها أو تحريفها، فلن تصمد طويلا وستنكشف سريعاً كل محاولات المخادعة والتحريف.. فالشعوب أصبح لها الدور الأول في التأثير على سياسات حكوماتها، ولم يعد ذلك الغطاء الذي يسمح بخديعتها، فإذا ما عمقنا فهمنا للعالم من حولنا، وتسلحنا بسلاح التواصل النابع عن معرفة وفهم للتلاقي والتعاون والمصالح المشتركة مع هذا العالم فإننا بالتأكيد سنحقق منجزات كبيرة في صراعنا ضد العنصرية اليهودية في فلسطين.
فالدولة اليهودية في فلسطين لم تنشأ في يوم وليلة، إنما هي حصيلة عمل مضن بدأ منذ القرن التاسع عشر بصبر وعزيمة وكان عملا شاقا اتسع على امتداد دول العالم وحكومات الدول الكبرى في ذلك الزمان، واستطاعت الصهيونية أن تستثمر كل إمكاناتها التنظيمية والاقتصادية والعلمية والسياسية والإعلامية في خلق ذهنية عالمية تساند دعوتها وحقها في إقامة دولتها المستقلة في فلسطين، وتغيير هذه الذهنية، العالمية المتعاطفة والمتضامنة مع الحق اليهودي – وهي معركة ضخمة لابد من خوضها – لن يتأتى بالصراخ والعصبية والتأزم وشتم العالم، فصراخ حناجرنا لا يتعدى فضاء بلداننا، ولن يجدي نفعاً، لأن خلق ذهنية عالمية تعترف بالظلم الذي وقع على الفلسطينيين على أيدي الصهيونية وتتعاطف معهم وتبدأ في الدفاع عن حقوقهم يتطلب عملا منظماً طويل الأمد يأخذ بعين الاعتبار كل الظروف والأحوال المستجدة في العالم، ويعمل على اختراق النظرة الدونية تجاهنا من قبل العالم، بتقديم بديل ديمقراطي وإنساني لأوضاعنا السياسية والاجتماعية.
وربما كان من المناسب أن أختم حديثي هذا بتلك الفقرة التي ختمت بها مقالي سالف الذكر على هامش ذكرى قيام دولة إسرائيل عام 48 في عدد مايو الماضي والذي قلت فيه إن هذه الذكرى تدعونا إلى: “أن نتأنى قليلا في سيرنا نحو البحث عن السلام العاجل بأي ثمن، وألا نلغي التاريخ من حساباتنا، فلقد صمد العرب أكثر من خمسين عاما، وقدموا تضحيات وتضحيات، لكنها لم تكن بلا ثمن. فالصراع العربي – الإسرائيلي خلق حالة قابلة للتطور لمصلحة العرب، إذا ما حاولوا أن يمسكوا بخيوطها بأيديهم ويستخدموا ما في التاريخ – تاريخ المنطقة والصراع – بعقل مفتوح وثقة بإمكاناتهم البشرية والجغرافية ومصادر قوتهم الاقتصادية – وأضيف بما لديهم من مخزون ثقافي واسع – فسيتمكنون في النهاية من الوصول إلى نتائج ملموسة لمصلحتهم واستقرار أوطانهم، والمنطقة بأسرها في نهاية المطاف”.
 د. سليمان إبراهيم العسكري
د. سليمان إبراهيم العسكري