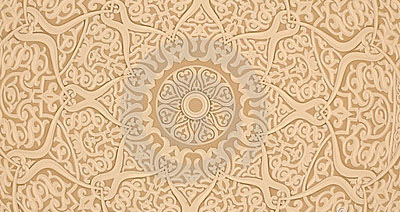إذا كنا نتفق على أن ثمة أزمة عميقة تعانيها الثقافة العربية في الوقت الراهن، فإن أولى طرق العلاج تكمن في وضع اليد على الجرح وتشخيص الواقع بشجاعة قبل إعطاء جرعات ضرورية من دواء يخلصنا من الداء… وينطلق بنا إلى نهوض جديد.
لن نتجاوز أزمتنا إلا بمشروع نهضوي شامل يعتبر الاختلاف الثقافي حافزاً للإبداع والتجديد.
الثقافة العربية بدأت في القرن العشرين بالدعوة إلى العقل وانتهت بالنأي عنه.
العمود الفقري لمواجهة التحديات يكمن في إعادة الديمقراطية إلى قلب الحياة العربية على مختلف الأصعدة.
عندما نتحدث عن حاضرنا العربي، وحاضر الثقافة العربية على وجه التخصيص، فإننا ندرك أن الحاضر لم يكن أبداً لحظة في ذاتها، مستقلة عما قبلها، وما بعدها، أي مستقلة عن الماضي والمستقبل. فماضينا بعض حاضرنا، والحاضر هو إمكانات المستقبل.
وقد تعوّدنا في حديثنا عن الثقافة في منتدياتنا الفكرية العربية أن نركز على الأعمال الإبداعية والكتابات الفكرية باعتبارها الشيء في ذاته، أي باعتبار هذا العمل أو ذاك الكتاب ابن صاحبه، وفي أفضل الأحوال ابن سياقه الاجتماعي.
والواقع أن هذا المنهج في التعامل مع الثقافة ينطوي على قدر كبير من إراحة الضمير من جانب المثقفين، الذين هم، كما يفترض، ضمير أمتهم. فهو يجنّبنا، من جهة، الاصطدام بالمؤسسات السائدة، السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية، ويسمح لنا في الوقت ذاته بتوجيه سهام نقدنا على نحو انتقائي إلى هذه المؤسسة أو تلك من أجل التنبيه (الخجول) إلى أخطاء فادحة في التعامل مع حاضرنا، أو تقصير مخجل في واجباتنا إزاء مستقبل أمتنا، الذي هو مستقبل أبنائنا.
لكن هذا المنهج يجرّد الوعي الثقافي من جوهره التقدمي، أي من قدرته على فهم جدل التفاعل بين الوعي النقدي بماضينا وبحاضرنا، ويحرمه بالتالي من القدرة على استقراء مستقبلنا.
وعلماء الاجتماع يعرفون الثقافة بأنها أسلوب حياة. ورغم إيجازه الشديد، فإن هذا التعريف يعني أن الثقافة هي مركب معقد لمزيج متفاعل يضم فنون المجتمع، ومعتقداته، وعاداته، ومؤسساته، وقوانينه، وأعرافه، وإبداعاته، وأساطيره، وفولكلوره، وخرافاته، ولغاته، وقيمه المختلفة. وبهذا التعريف الرحب، تصبح الثقافة هي كل مجالات الحياة، وتصبح الثقافة هي ما يفرّق بين الأمم والشعوب المختلفة. وهو ما يعني أن قراءتنا للمشهد الثقافي العربي يجب ألا تنفصل عن قراءتنا للمشاهد العربية الأخرى، وأقصد بذلك المشاهد السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
ولكي نفهم واقع أي ثقافة بشكل عام، والثقافة العربية بشكل خاص، يتعيّن علينا أن ندرك جيداً طبيعة العلاقة المعقّدة التي تربط بين الثقافة والسلطة. وكما يقول دافيد روثكوبف، فإن: (الثقافة ليست إستاتيكية، فهي تنشأ عن احترام منهجي حثيث لعادات وتقاليد منتقاة… واللغة، والمعتقدات، والأنظمة السياسية والقانونية، والأعراف الاجتماعية هي إرث المنتصرين وأبناء السوق، وتعكس حكم السوق على الأفكار عبر التاريخ الشعبي. ويمكن النظر إليها بحق أيضاً باعتبارها نتاجات حيّة، مفردات متفرّقة ترتحل عبر السنين من خلال تيارات التعلم، والقبول الشعبي، والتمسك غير الواعي بالعادات. وتستخدم الثقافة من قبل منظمي المجتمع، لفرض وضمان النظام، الذي تغيّرت مبادئه مع مرور الزمن وفقاً لما تمليه الحاجة، وأي بحث عابر لتاريخ الصراع يبين تماماً لماذا توقع صامويل هنتنجتون، في كتابه (صدام الحضارات The Clash of Civilization)، حدوث صراع عبر خطوط الصدع الثقافي، وهي الخطوط التي تندلع عندها الصراعات تحديداً. والأسوأ من ذلك أن الاختلافات السياسية كثيراً ما تكرّس من خلال ارتباطاتها بالجذور الغامضة للثقافة، سواء الروحية أو التاريخية. ونتيجة لذلك يصبح تهديد ثقافة المرء تهديداً لدينه أو لأسلافه، وبالتالي تهديدا لجوهر هويته. وقد استخدمت هذه الصيغة الملتهبة لتبرير العديد من أسوأ الأفعال الإنسانية).
المشهد الراهن
كان العقد الأخير من القرن العشرين واحداً من أكثر العقود صخباً وحراكاً وتقلباً في تاريخ الإنسانية. فقد بدأ هذا العقد بانهيار مفاجئ للعالم الذي عرفناه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتخلصت البشرية من سيف الحرب الباردة المصلت على رقبتها. ومع انهيار العالم الثنائي الأقطاب الذي عرفناه طوال معظم القرن العشرين، وظهور نظام عالمي جديد وحيد القطب، ظن الكثيرون أن البشرية تخلصت أخيراً من أزمتها، وأننا نقف على أعتاب حقبة تاريخية جديدة سيحل فيها منطق العقل محل منطق القوة، وتحدث البعض عن (نهاية الأيديولوجيات) و (نهاية التاريخ)، وعن الانتصار النهائي للرأسمالية والديمقراطية.
لكن نهاية العقد أذنت بتبدد الكثير من هذه الأحلام/الأوهام. فقد انقشعت الآمال التي ارتبطت بمولد النظام العالمي الجديد نتيجة لإخفاقاته المتوالية (الشرق الأوسط، والصومال، ويوغوسلافيا السابقة، والشيشان، إلخ).
ومظاهرات سياتل كشفت زيف الجنة الموعودة التي بشّر بها دعاة اقتصادات السوق والتجارة الحرة، والنزاع بين الشرق والغرب حل محله صراع بين الشمال والجنوب، والجنوب والجنوب. وبؤر التوتر التي خمدت ظهرت مكانها بؤر جديدة أكثر تفجّراً. ومع تفاقم المشاكل العرقية، وتفكك الكثير من الدول، خاصة في شرق ووسط أوربا وإفريقيا، واشتداد أزمة الخواء الروحي، وصعود التيارات الفاشية في أنحاء عدة من العالم، دخل العالم القرن الحادي والعشرين واللايقين هو العنوان، بدءاً من واقع البشرية اليوم، وحتى مستقبلها ذاته.
إن العالم كله اليوم، يواجه مفترق طرق حاداً. والتاريخ في مثل هذه المفترقات القاسية يضع الشعوب وثقافاتها في حالة من التشوّش والقلق تؤثر لا محالة على الفرد والمجتمع. وهذا ما ينطبق بالطبع – وربما على نحو أكثر درامية – على شعوبنا وثقافتنا العربية. وتصبح حالة التشوش والقلق هذه أكثر عمقاً عندما نجد أنفسنا مطالبين، ونحن على أبواب الألف الثالثة بعد الميلاد، بحضور فعّال في ساحات هذا العصر، الذي لا يعترف إلا بمن يمتلك مفاتيح التعامل معه.
ومع دخولنا إلى القرن الحادي والعشرين، وفي هذه اللحظة شديدة الخصوصية والتفرّد من تاريخ العالم بشكل عام، وتاريخ منطقتنا بشكل خاص، تنتاب العالم موجة من التحوّلات جعلت حياة المجتمعات كلها مختلفة حتى في الجذور، عنها في العصور السابقة. وتحت راية العولمة، ينحسر تأثير الدولة القومية ونفوذها على عالم السياسة لصالح الشركات عبر القومية. وهذا الضعف تسببه بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، قوى السوق الكونية، حيث تؤثر هذه القوى الاقتصادية على نحو مباشر في الدولة القومية من خلال تقييد وظائفها الاقتصادية، وخلق ثقافة كونية متجانسة التكوين تهمش العواطف القومية. غير أن هذه القوى تولد أيضاً رد فعل ثقافياً معاكساً، يعيد بعث هويات أقدم حتى من الدولة القومية. ومن المؤكد أن هذه التأثيرات كونية الطابع، لكن الأمر المؤكد أيضاً أن العلم الاجتماعي – على الأقل العلم الاجتماعي الذي عرفناه حتى الآن – يعجز عن تفسير هذه التغيرات.
قلنا إن هذه التطورات تفرض مجموعة من التحديات الثقافية على كل أمم الأرض. وهي تشكل بالنسبة للأمم العريقة ذات التراث الثقافي الوطيد كالعرب، تحديات أكثر قسوة وخطراً. وإذا كانت بلدان الغرب المتقدمة تواجه أزمة ثقافية في هذا العصر، فهي أزمة تختلف نوعياً عن الأزمة التي تواجهها الشعوب الأخرى ومنها بلدان عالمنا العربي.
ويمكن أن نفهم خصوصية أزمة الثقافة العربية إذا أدركنا أن الثقافة العربية بدأت هذا القرن العشرين بالدعوة إلى العقل، وانتهت بتنائيها عنه، وعلى مدى عقود عشرة، راحت تعاني في صراعها بين عقلانيتها ولاعقلانيتها، ونجحت أحياناً وأخفقت في أحايين كثيرة في عدد من قضاياها الأساسية. لكنها في كل الأحوال، لم تكمل أبداً مشوار نهضتها المعرفية، والعلمية والتنويرية.
وأزمة الثقافة في حالتنا تتجلى في تخلّف البنية الحضارية لمجتمعاتنا عن معطيات العصر، وقصورها عن التلاؤم المناسب معها، وفي عجز وسائلها عن الدفاع عن ذاتها إزاء أخطار القوى الخارجية من مختلف الأنواع. ولأن حضارة العصر الحاضر، وبالتالي ثقافته، مختلفتان نوعياً عن الحضارات الإنسانية السابقة وثقافتها، فإن مجتمع الغد الآتي مليء بالمتغيرات والتحديات التي تقوم على (الانفجار المعرفي) و(الثورة التقنية)، فضلاً عن الثورة المعلوماتية ثورة الاتصالات التي فرضت في أجواء الثقافة العالمية السرعة البالغة، وسعة المعلومات وتشابكها، وإلغاء الأبعاد وترابطها. وهذه الثورة وضعت المستقبل في يد الثقافات الأقوى المالكة لوسائل الاتصال.
إن أي رصد لواقعنا العربي لا يمكنه إنكار هول التردّي الذي وصلنا إليه، وحجم التحديات المفروضة علينا إذا أردنا النهوض من سباتنا الطويل. والعمود الفقري لهذا النهوض هو إعادة الديمقراطية إلى قلب الحياة العربية على مختلف الأصعدة. فقد غابت الديمقراطية عن التطور السياسي والثقافي والاجتماعي العربي في العصر الحديث، ولم تحتل الأولوية في جدول أعمال معظم – إن لم يكن كل – التيارات الفكرية والسياسية العربية. بل إن بعض التيارات رفضتها جملة وتفصيلاً بحجج متباينة. ومن أوجه التردّي الأخرى الجمود والتقليدية على الصعيدين الفكري والاجتماعي، وهجوم قيم الريف والبادية على المدينة، وغياب العقلنة والعلمية، والتخلف الاقتصادي، والتعليم التلقيني، والقائمة تطول.
وللتدليل على حجم هذا التردي، نشير هنا إلى إحصائية صدرت عن منظمة اليونيسكو في العام 1996 توضح حجم الهوّة الشاسعة التي تفصل بين الوطن العربي (250 مليون نسمة و 6759 إصدارا في السنة)، وبين بلاد مثل إسبانيا (39 مليون نسمة و41816 إصدارا)، وإسرائيل (5،4 مليون نسمة و4608 إصدارات). ومن الواضح أن العلة تعود ليس فقط للأمية الأبجدية، وإنما أيضاً الأمية الثقافية والعزوف عن القراءة. فالوطن العربي الذي يزيد تعداده عن ستة أمثال تعداد إسبانيا، يصدر كتباً لا تتجاوز سدس ما تصدره إسبانيا. وتتضح صورة المأساة أكثر عندما نعرف أن معظم الكتب المؤلفة والمترجمة هي في مجالات السياسة ثم الدين والأدب والتاريخ والنقد، أما العلوم والتكنولوجيا فإنها مؤجلة حتى نستفيق من غفوتنا.
ويشير شوقي جلال (في مسح ميداني أجراه حول وضع الترجمة في الوطن العربي ونشره ضمن كتاب (الترجمة في الوطن العربي) – مركز دراسات الوحدة العربية) إلى أن: (إجمالي الكتب المترجمة في الوطن العربي منذ الخليفة المأمون وحتى يومنا هذا يصل إلى عشرة آلاف عنوان، أي يساوي ما ترجمته إسرائيل في أقل من 25 سنة من وجودها، أو ما ترجمته البرازيل في أربع سنوات، أو ما ترجمته إسبانيا في سنة واحدة تقريباً).
وبالنسبة لكتب الأطفال، نجد الصورة أكثر قتامة، فما يُطبع من كتب الأطفال (غير المدرسية) في دول العالم العربي كافة لا يزيد على 10 في المائة مما طُبع لهم في بلجيكا، رغم أن تعدادها لا يزيد على 8 في المائة من سكان العالم العربي. وإذا قارنا بين دول العالم من حيث ما يُطبع من كتب الأطفال، فسنجد أن نصيب الطفل الواحد من الكتب في العام الدولي للطفولة (1979) كان 47 كتاباً في روسيا، و9،3 كتاب في الولايات المتحدة، و6،2 كتاب في إنجلترا، بينما إذا حاولنا استخراج هذه النسبة في الوطن العربي لوجدنا أن نصيب الطفل الواحد ربما لا يتعدى سطراً واحداً في كتاب.
وحتى على مستوى الصناعة الورقية، كان استهلاك المواطن العربي من الورق في العام 1982 حوالي 9،10 كيلوجرام، بينما وصل متوسط استهلاك الفرد من الورق في العالم في العام 1981 نحو 39 كيلوجراما سنويا.
وفي دراسة أجراها الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة في العام 1983، تبين أن الدول العربية لو كانت قد قررت في العام 1982 إقامة مشروعات عربية لإنتاج عجينة الورق وإنتاج الورق ذاته لكانت الفجوة قد تقلصت، وكان الوطن العربي سيصبح قادراً على إنتاج 75 في المائة من حاجاته الورقية في العام .2000 وكان ذلك سيتطلب توظيف استثمارات لإنشاء هذه المصانع تقدر تكلفتها بأرقام 1982 بحوالي 20 مليار دولار. وإذا كانت هذه المصانع قد أقيمت في الفترة 1982- 2000، فإنها كان من الممكن أن تنتج ما قيمته 550 مليار دولار من الورق بأسعار .1982
وحتى على مستوى قراءة الصحف، التي لا تعكس بالضرورة حقيقة المستوى الثقافي، فإن الأرقام أيضاً تثير الفزع.
هذا هو واقعنا، وهذه هي حقيقة وضعنا المأساوي على خارطة الحضارة العالمية. نحن هامشيون، ومهمّشون، ووضعنا لا ولن يتحسّن، بل سيزداد سوءاً. وهنا لن تنفعنا الثروة، فثرواتنا كلها لن تنقلنا من موقعنا الهامشي. وغرورنا باستخدام أحدث منتجات العصر الاستهلاكية لن ينفعنا عندما يسألنا أبناؤنا ماذا فعلتم من أجلنا? الثروة الحقيقية ليست في امتلاك المال، أو الاستمتاع بالسلع الاستهلاكية، بل هي في النشاط الإنتاجي والإبداعي، وقدرة المجتمع ذاته على التجدد، وتجديد ينابيع الإبداع فيه، وامتلاك المعرفة وأدواتها.
والواقع أن كل هذه الأخطار الخارجية والأنواء الداخلية تفرض إعادة النظر في الوضع الثقافي العربي كله لتحديثه، وإعطائه الحركية الحيوية اللازمة، وجعله في مستوى المعطيات العالمية المتطورة. وإذا أخذنا كل هذا بعين الاعتبار فسندرك أننا لن نتجاوز أزمتنا – أي أزمة الثقافة العربية – إلا بمشروع عربي نهضوي شامل ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمية وثقافية. مشروع لا يتجاهل الاختلاف الثقافي مع الآخر، لكنه يعتبره حافزاً للإبداع والتجديد. مشروع يسعى إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي وإعلاء شأن الإنسان وكرامته وحقوقه، ويتعامل مع تيارات الحضارة العالمية بأفق رحب يتجاوز القوالب الأيديولوجية الجامدة، والأحكام المسبقة، والانغلاق على الذات، مشروع يستند أساساً إلى القدرة على نقد الذات، وإعادة إنتاج المعرفة من قلب التعامل الإيجابي مع حقائق العصر.
والحقيقة أن إنتاج هذا المشروع لن يتم فقط في أروقة الحكومات العربية، بل هو منجز جماعي تسهم فيه الحركة الثقافية العربية بالمعنى الأرحب للكلمة، بما في ذلك صنّاع الثقافة ومنتجوها ومبدعوها، ومؤسسات القطاع الخاص، والاتحادات، وجمعيات المجتمع المدني.
وفي إطار مشروع من هذا النوع، تصبح مجالات التعاون الثقافي العربي لا حصر لها. وأول هذه المجالات هو الكتاب. فمقولة (إن أمة تقرأ، هي أمة تحيا) مقولة صحيحة تماماً. كما أن مزيداً من الكتب يعني مزيداً من التقدم. ولا يؤثر في مصداقية هذه المقولة الحضور الكثيف والانتشار الواسع لوسائط الإعلام المرئية في حياتنا اليومية المعاصرة. فمازال الكتاب، وسيبقى إلى أمد غير منظور، الأداة الأولى للعلم والثقافة. وأمة لا تقرأ لا مكان لها على خريطة العصر.
ومن المؤسف والمؤسي أنه في عصر القنوات التلفزيونية الفضائية وتطور وسائط ووسائل الاتصال والإعلام، فشلت تماماً كل أشكال الرقابة على المادة الثقافية المرئية والمسموعة، ليبقى اليتيم الوحيد الخاضع للرقابة والقيود الجمركية هو الكتاب. وقوائم الكتب الممنوعة تتسع باستمرار في معظم البلدان العربية. بل إنهم أصبحوا على الحدود، يفتشون صفحاتها بحثاً عن استعارة موحية، أو تورية خبيثة، أو فكرة محرّضة، ولم تسلم حتى كتب التراث من هذه الهجمة العبثية.
إن مستقبل ثقافتنا العربية مرهون بمستقبل الأمة العربية ذاتها. ولن يحدث النهوض الثقافي المنشود مالم يكن هناك نهوض عربي آخر على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لكن الأهم من هذا وذاك هو أننا لن نحقق أي نهوض مادامت الديمقراطية غائبة، أو مدجنة، في معظم عالمنا العربي. ولن ننجو من أزمتنا الراهنة من دون أن تتبنى الثقافة العربية الدعوة إلى تنوير العقل، وتستعيد رسالتها الإنسانية المنفتحة على العالم التي تعلي من شأن العقل والإبداع. فقد ساد العرب الدنيا عندما أبدعوا، وترجموا، واكتشفوا وطبّقوا. والآن يتعين علينا أن نبذل الجهد نفسه إذا أردنا الخروج من مأزقنا الراهن. وما أحوجنا الآن في هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ عالمنا العربي – وتاريخ العالم – إلى شجاعة القلوب والعقول. إنها دعوة إلى المصارحة ونقد الذات، وإعادة قراءة واقعنا على كل الأصعدة، فعلى ذلك سيتوقف الكثير مما يتعلق بمستقبل الثقافة العربية، وبالصورة التي سنكون عليها في الألف الثالثة.
 د. سليمان إبراهيم العسكري
د. سليمان إبراهيم العسكري